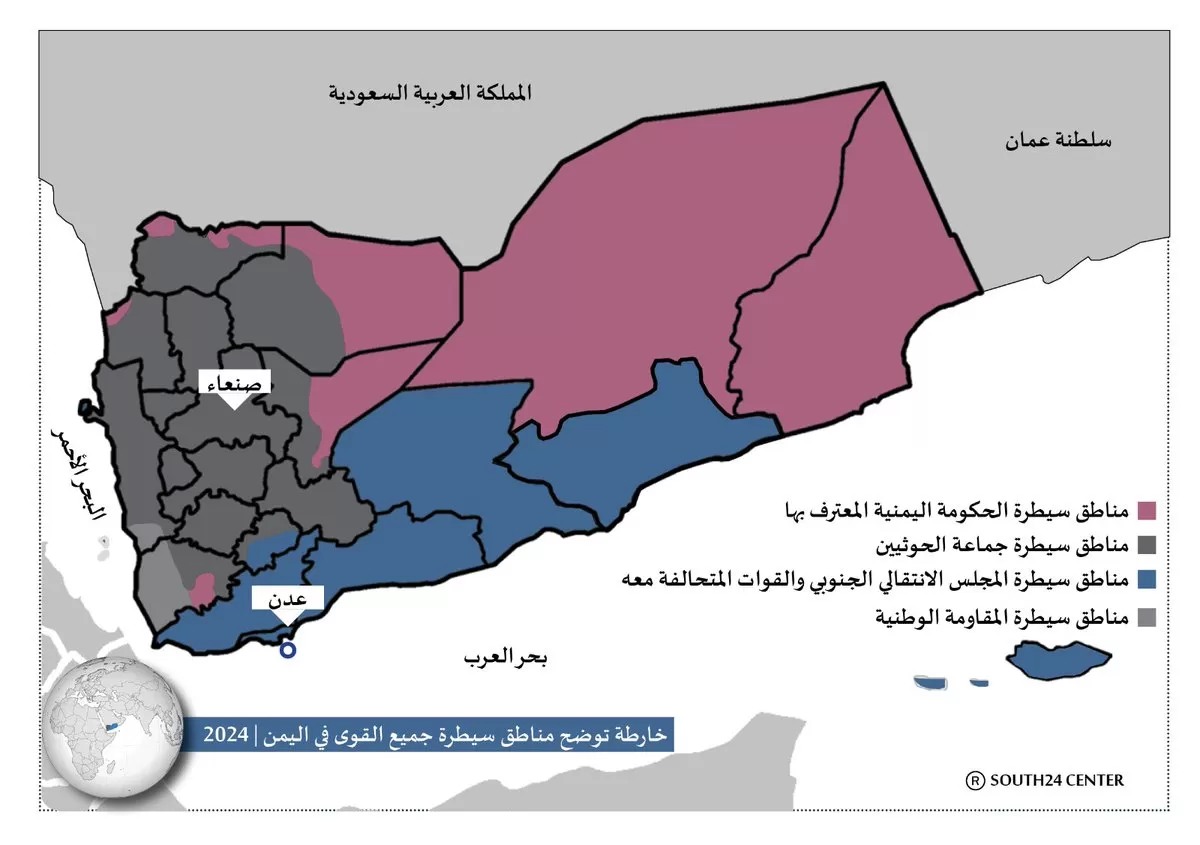الشهيد الصالح الساعات الاخيرة من حياته
الناقد نت - خاص / تقرير : زين العابدين الضبيبي
في صباح الرابع من ديسمبر 2017، وقبل أن تشرق شمس صنعاء، كان رجلٌ يتقدم نحو مصيره بخطى بطيئة، وسلاحٍ شخصي لا يكاد يُرى أمام فيضان البنادق المحيطة به. تجاوز السبعين، لم يعد في جسده متسع للمعارك، لكنه اختار أن يخوض معركته الأخيرة، لا ليربحها، بل ليصالح بها نفسه، وتاريخه، والبلد الذي أحبه على طريقته، وأوجعه على طريقته.
علي عبدالله صالح، الرئيس الذي حكم اليمن لأكثر من ثلاثة عقود، وجد نفسه في النهاية وحيدًا، محاصرًا، بين أنياب ضباع الكهوف وخذلان ثعالب المصالح ، الذين تخلوا عنه وعن أنفسهم بقسوة لا تُشبه سوى لحظات الغدر الكبرى في التاريخ وقد اكتوى الكثير منهم بنارها، ولم يصمد معه غير الخُلص من الأوفياء.
لم يُغادر. رغم أن العروض كانت كثيرة. طائرات تنتظر، ووسطاء يتحركون حتى اللحظة الأخيرة. كان بإمكانه أن ينجو، أن يلجأ إلى حيث اللجوء آمن، وأن يكتب بيانًا منفيًا لا يحمل سوى الذكرى. لكنه، حين اقتربت النهاية، أدرك أن الخروج الحقيقي ليس بالنجاة، بل بالوقوف، حتى لو أمام جدار الموت.
هو لم يكن حاكمًا حين اجتاح الحوثيون صنعاء، ولم يكن بيده قرار الجيش الذي أُعلن أنه "محايدًا" بأمر من قيادة الدولة حينها. لكنه ربما ظن ــ حين اختار مجبرًا أن يؤجل موته، بالشراكة مع خصومه، ــ أنه لم يكن يهدم الدولة، بل كان يحاول ــ بما بقي له من نفوذ ــ أن يحمي مؤسساتها من الانهيار الكامل وسط فوضى ما بعد الربيع. رأى الخطر أكبر من خصومة سياسية، وأراد أن يوازن الكفة، وفق منطقه، بما يُبقي على كيان الدولة حيًا. فاستمر الحال كما هو إلى أن اكتشف، كما اكتشف كثيرون، أن الحوثيين لم يكونوا شركاء وطن، بل مشروعًا يتجاوز الجميع وأظنه كان يدرك ذلك منذ البداية وراهن على عبقريته فخذلته وخذلت شعبًا بأكمله في لحظة فارقة من حياة كل اليمنيين.
وحين نزع عنهم الغطاء، ورفع صوته داعيًا إلى الانتفاضة، ضد تجريف الهوية، والعبث بالمناهج، والاستئثار بالسلطة، وهوشمة الدولة، كان يعرف أنهم سيأتون لقتله. لكنه لم يتراجع. لم يُساوم، لم يهرب، لم يبحث عن فتوى تُحل له المغادرة. حمل سلاحه، ووقف وسط منزله، يوزع النظر بين الوجوه التي يعرفها، ويقول بثباتٍ عجيب:
"لن أهرب. هذه صنعاء… ولا حياة بعدها."
في فناء منزله، كانت اللحظة أكبر من السياسة، وأكبر من الحسابات. كان مشهد رجلٍ يذهب إلى موته بوعيٍ كامل، لا بدافع البطولة الجوفاء، بل كمن قرر أن يدفع ثمن الخيارات، ويمنح تاريخه – المعقّد – خاتمة تستحق أن تُروى.
قاتل ببندقيته الشخصية، ومعه حفنة من المقاتلين. قاوم حتى خارت الطلقات، ثم خرّ شهيدًا، في مشهدٍ لا يُنسى:
جسدٌ مسجّى على تراب العاصمة، ووجهٌ مرفوع نحو السماء، كمن يصلي دون صوت. وقد هشمت مخالب الظلام رأسه الجمهوري العنيد.
لم يمت علي عبدالله صالح بطلًا نقيًّا، _ بحسب وجهة نظر خصومه_ ولا زعيمًا معصومًا من الأخطاء. لكنه مات رجلًا. مات وهو يواجه، لا وهو يساوم. مات في بلده، لا في فندق. مات ورائحة البارود في أنفه، لا عطر السياسة في يده. مات كما يموت من قرر أن يُكفّر، وأن يُثبت – لنفسه قبل الناس – أنه لم يكن جبانًا، ولا خائنًا، ولا بائعًا للجمهورية، وأنه أولى الناس بها، وعلمنا فعليًا كيف يكون الدفاع الحقيقي عنها، وما هي الطريقة المناسبة لاستعادتها.
ومن بعده، لم يبق شيءٌ على حاله. سقطت كل المؤسسات التي حاول حمايتها، وتحولت صنعاء وغيرها من المدن التي يجثم الكهنة على صدرها إلى ثكن طائفية بغيضة، مثخنة بالجوع والوجع، وانكشف المشروع الطائفي في أقبح صوره. كأن موته كان آخر ما تبقى من ملامح الدولة، وآخر ظلٍ لرجلٍ، مهما اختلف الناس حوله، لم يكن يومًا صغيرًا.
وحين تراجع الجميع، وابتلعتهم عواصم الشتات، بقيت صورة الزعيم وهو يواجه مصيره، درسًا مؤلمًا، لمن ظنوا أن التاريخ يُكتب من وراء الميكروفونات، وصفحات الفيس وتويتر،
في زمن الخيانات، كان موته، بكل ما فيه من دمٍ ووجع، أصدق ما كُتب باسم الوطن ومثله كل الأبطال العظماء الذين اختاروا الخلود، وركضوا إليه على حد أرواحهم.
رحم الله الزعيم صالح، وكل شهداء الجمهورية الأبطال، في كل جبهة وميدان.